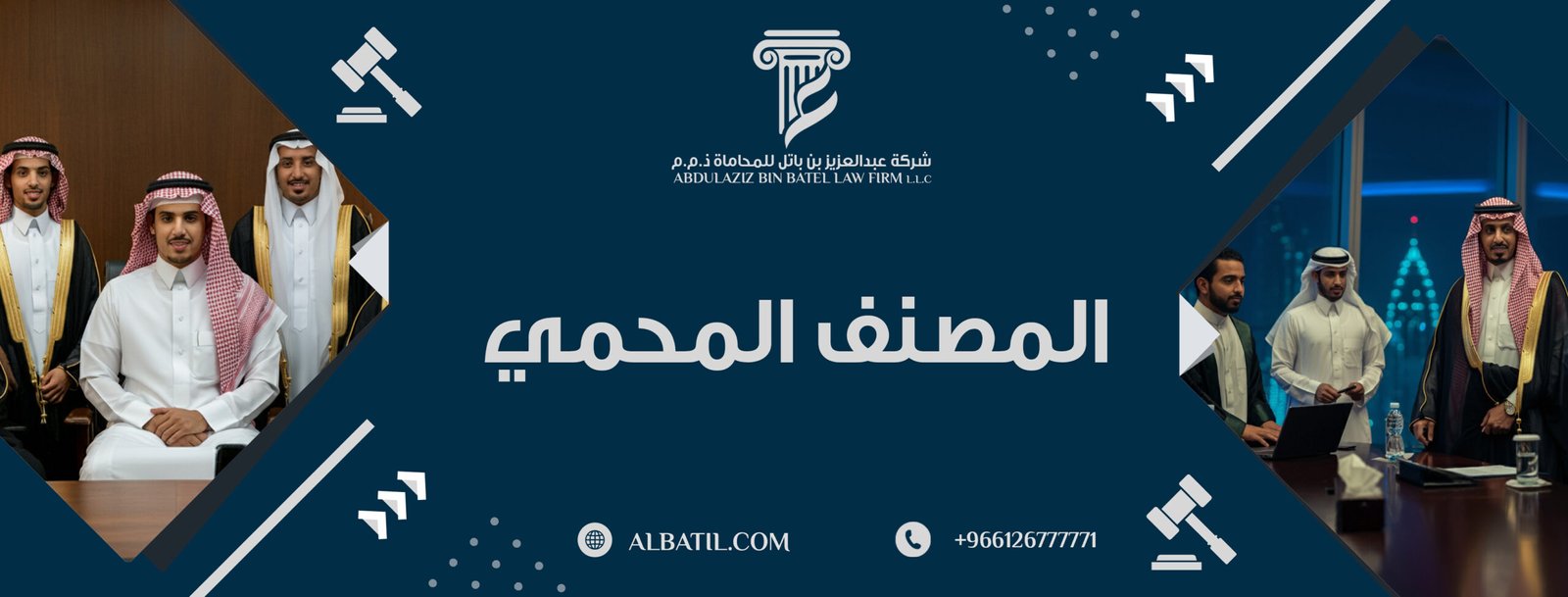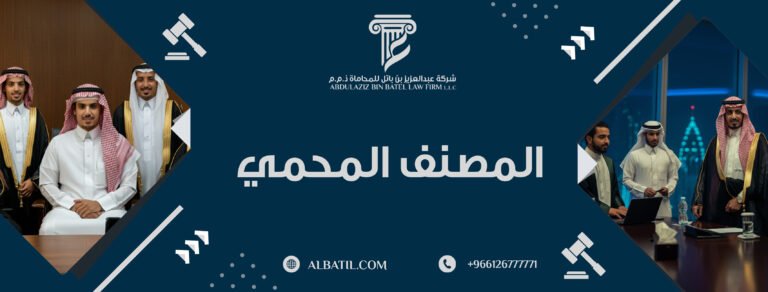يُعَدّ المصنف المحمي مركزًا نظاميًّا دقيقًا لا يُمنح لأي عمل فني أو أدبي أو علمي إلا إذا استوفى شروطًا موضوعية وشكلية محكمة، حدّدها نظام حماية حقوق المؤلف السعودي بعناية بالغة. فهو لا يُطلق بوصفه مجرد عنوان قانوني عام، بل يُبنى على معيار الابتكار الأصيل، ومدى تحقّق هذا الابتكار في مضمون العمل وشكله، بصرف النظر عن نوع الوسيط أو الغرض من إنتاجه. ومن هنا تتضح المفارقة النظامية بين ما يُعد مصنفًا محميًا، وما يُستثنى من الحماية، رغم أنه قد يبدو إبداعيًا في ظاهره.
وانطلاقًا من هذا المفهوم المحوري، جاء نظام حماية حقوق المؤلف، ولائحته التنفيذية المعدلة، ليضعا خارطة طريق دقيقة تميز بين أنواع المصنفات المحمية، وتوضح خصائص كل منها، وشروط اكتسابها للحماية، وتحدد مَن يملك الحقوق عليها، سواء كان فردًا، أم جماعة، أم جهة رسمية، أم حتى الدولة نفسها كما هو الحال في التراث الشعبي. وتتسلسل هذه القواعد النظامية ضمن بناء قانوني متماسك، يبدأ بتعريف المصنف، ويمتد إلى تصنيف أنواعه، وتحديد الاستثناءات، وضبط الملكيات، وصولًا إلى التنظيم الكامل للعلاقة بين المبدع والمصنف المحمي الذي أنتجه.

أولًا: ما هو تعريف المصنف؟ وما هي أنواعه المحمية؟
ينصرف مصطلح المصنف المحمي وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف إلى كل عمل أدبي أو علمي أو فني يتميز بالابتكار، أيًا كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه أو أهميته، متى توافرت فيه الشروط النظامية التي تُكسبه الحماية القانونية. وقد جاء هذا التعريف في المادة الأولى من النظام، والتي نصت على أن المقصود بالمصنف هو: “أي عمل أدبي أو علمي أو فني”، ويُشترط فيه أن يكون مبتكرًا ابتكارًا أصيلًا حتى يدخل ضمن نطاق الحماية النظامية.
ولم يقتصر المنظم على هذا التعريف العام، بل دعّمه بعدد من التعريفات المكملة، من بينها تعريف المصنف المشترك بأنه: “المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك”، وكذلك تعريف المصنف الجماعي بأنه: “المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه، بحيث لا يمكن فصل عمل كل مشترك فيه”. كما أدرج تعريف المصنف المشتق بوصفه: “كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له”، وهو ما يعني أن المصنف المحمي قد يكون أصليًا أو مشتقًا، بشرط استيفائه عناصر الحماية.
ومن خلال المادة الثانية من النظام، حدد المنظم أمثلة تفصيلية لما يُعد من المصنفات المحمية، فذكر من بينها المواد المكتوبة، والمحاضرات، والخطب، والمسرحيات، والمصنفات المعدة للإذاعة، وأعمال الرسم والعمارة والفنون التطبيقية، والمصنفات السمعية والبصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والخرائط، والمخططات، والرسوم الكروكية، والبرمجيات، وغيرها. ويُشترط في كل هذه المصنفات أن تتمتع بطابع ابتكاري، حتى تدخل ضمن نطاق المصنف المحمي.
وتوسّعت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تفصيل هذه الأنواع، حيث نصت في المادة الثانية منها على أمثلة أخرى للمصنفات التي تتمتع بالحماية، ومن بينها: المسرحيات، والمصنفات التي تؤدى بحركات فنية، والتمثيليات الإيمائية، والمصنفات السينمائية، وأعمال الحفر والطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية، والتقارير الإخبارية، مع التأكيد على أن الحماية لا تشمل الوقائع الإخبارية اليومية في ذاتها، وإنما الصياغة الإبداعية لها.
وإلى جانب المصنفات الأصلية، قررت المادة الثالثة من النظام حماية المصنفات المشتقة، وهي تلك التي تنشأ انطلاقًا من مصنف أصلي، كأعمال الترجمة، والتلخيص، والشرح، والتحوير، والتحقيق، والموسوعات، والمختارات الأدبية أو الفنية أو العلمية، وقواعد البيانات إذا تميزت بترتيب أو انتقاء مبتكر. وهنا يظهر أن المصنف المحمي قد يتخذ صورًا متعددة ومتجددة، تشمل الابتكار الأصلي والابتكار القائم على إعادة إنتاج معرفي أو فني لمحتوى سابق.
أما من حيث الضوابط المفهومية للمصنف المحمي، فقد وضعت اللائحة التنفيذية في مادتها الأولى تعريفًا دقيقًا للابتكار، باعتباره الطابع الشخصي الذي يميز المصنف، ويُكسبه الجدة والتميّز، ويجعله تعبيرًا خاصًا بالمؤلف عن فكرته، سواء من خلال الطريقة أم الأسلوب أم المعالجة. وبالتالي، فإن جوهر الحماية في المصنف المحمي يتمثل في هذا الطابع الابتكاري، لا في الفكرة المجردة أو المعلومات الخام.
وبناءً عليه، فإن نطاق المصنف المحمي– كما استقر في نصوص النظام واللائحة– يتسم بالاتساع والمرونة، ليشمل كافة أشكال التعبير الأدبي أو العلمي أو الفني التي تتوافر فيها عناصر الإبداع والابتكار، سواء كانت أصلية أم مشتقة، مكتوبة أم شفهية، أدائية أم سمعية أم بصرية. ولا يُعتد بنوع الوسيط أو طريقة العرض، ما دام العمل نفسه يتمتع بالخصائص الجوهرية التي تُكسبه صفة المصنف المحمي النظامية.
وبهذا التحديد، يكون المنظم السعودي قد وضع إطارًا قانونيًا محكمًا لحماية المصنف المحمي، يضمن شمولية التغطية، ووضوح المعايير، ويمنح الهيئة السعودية للملكية الفكرية المرجعية الكاملة في ضبط نطاق الحماية ومداها وفقًا للمستجدات الإبداعية والمعرفية المتغيرة.
ثانيًا: ما هي المصنفات المستثناة من الحماية؟
لا يدخل كل عمل فني أو أدبي أو علمي ضمن مفهوم المصنف المحمي، بل استبعد النظام صراحةً عددًا من الأعمال والمواد التي لا تُعد محلًا للحماية، متى افتقرت للابتكار أو كانت وثائق رسمية بطبيعتها. وقد نصت المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف على استثناءات محددة لا تخضع لأحكام الحماية المقررة بموجب النظام، وهي على وجه الخصوص: الأنظمة، والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام المنظمة لتداولها.
كما استثنى النظام ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من أخبار يومية أو حوادث ذات طابع إخباري، باعتبار أن هذه الأخبار بطبيعتها لا تنطوي على قدر من الابتكار يجعلها ضمن نطاق المصنف المحمي. وأخيرًا، أُخرجت الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، والمفاهيم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة من نطاق الحماية؛ لأنها تُعد مفاهيم أولية لا تملك صفة التعبير الفني أو الإبداعي.
وفي تأكيد ذلك، جاءت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، موضحةً أن على المؤلفين مراعاة الأحكام النظامية الخاصة بتداول الوثائق الرسمية، والحصول على الموافقات اللازمة عند الرغبة في نشر أو ترجمة أي منها، بما في ذلك الأنظمة، واللوائح، وقرارات الجهات الرسمية، مما يعزز من حصر نطاق الحماية القانونية للأعمال التي تستوفي شروط الابتكار، دون سواها من الوثائق الرسمية أو المواد العامة.
وبذلك، يظهر أن النظام لم يكتف ببيان ماهية المصنف المحمي، بل حرص أيضًا على رسم حدود واضحة لما لا يدخل في هذا المفهوم، بما يضمن منع التوسع غير المشروع في نطاق الحماية القانونية، وحصرها في الإبداعات التي تستحق الحماية فعلًا.
ثالثًا: ما الفرق بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي والمصنف المشتق؟
تميّز النظام بين أنواع متعددة من المصنف المحمي، وذلك وفقًا لهيكلية إنتاج المصنف وعدد المشاركين فيه وطبيعة الإبداع ذاته، وكان أبرز هذه الأنواع: المصنف المشترك، والمصنف الجماعي، والمصنف المشتق.
فقد نصت المادة الأولى من نظام حماية حقوق المؤلف على أنه: المصنف المشترك هو المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم فيه أم لم يمكن. أما المصنف الجماعي، فهو الذي يتم إنتاجه بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري، ويندمج فيه إسهام الأفراد المشاركين ضمن إطار واحد لا يمكن تمييز أجزاءه، ويُنسب إلى من نظّم الابتكار ونشره تحت اسمه.
وتفصيلًا لذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أنه: “إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم، فإنهم يعدون شركاء بالتساوي، ولا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك”، وهو ما يدل على أن المصنف المحمي في هذه الصورة يُعد مملوكًا على الشيوع. أما إذا أمكن فصل الإسهامات، فللمؤلف الحق في استغلال الجزء الخاص به ما لم يضر بالمصنف الكلي، وفقًا للفقرة الثانية من المادة ذاتها.
وفيما يخص المصنف الجماعي، أكدت الفقرة الثالثة من المادة السادسة على أنه: “للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي نظم المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف”، مما يعني أن صفة المصنف المحمي تنصرف إلى الجهة المنتجة وحدها، دون الاعتداد بمساهمات الأفراد ما داموا لا يُميزون عن المصنف ككل.
أما المصنف المشتق، فقد خصّه النظام بالحماية من خلال المادة الثالثة، التي قررت أن المصنفات التالية تدخل ضمن مفهوم المصنف المحمي متى تميزت بالابتكار: الترجمة، والتلخيص، والشرح، والتحوير، والموسوعات، والمختارات، وقواعد البيانات، بشرط أن يكون لها طابع مبتكر من حيث ترتيب أو انتقاء المحتوى. وأكدت نفس المادة على أن حماية هذه المصنفات المشتقة لا تخل بالحماية المقررة لأصحاب المصنفات الأصلية.
وتتلاقى هذه الأحكام مع ما ورد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية التي عرفت الابتكار بأنه: الطابع الشخصي الذي يميز المصنف ويمنحه تميزًا وجدةً، مما يعني أن المعيار الجوهري لاكتساب صفة المصنف المحمي في هذه الصور المختلفة هو توافر الابتكار، سواء أكان أصليًا أم مشتقًا، فرديًا أم جماعيًا.
وبذلك يكون النظام قد رسم إطارًا دقيقًا لأنواع المصنف المحمي، محددًا خصائص كل نوع، وضوابط استغلاله، ومراكز الحق فيه، على نحو يُعزز من عدالة الحماية، ويحول دون الخلط بين الحقوق الفكرية في صورها المتنوعة.
رابعًا: ما المقصود بالتراث الشعبي؟ ومن يملك حقوقه؟
يشكل التراث الشعبي أحد أبرز صور المصنف المحمي ذات الطبيعة الخاصة؛ نظرًا لارتباطه بالهوية الثقافية للمجتمع ونشأته في بيئة جماعية دون أن يُنسب إلى مؤلف فردي. وقد عرّف نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الأولى التراث الشعبي (الفلكلور) بأنه: “جميع المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي”.
ويترتب على هذا التعريف النظامي أن التراث الشعبي يتمتع بالحماية القانونية باعتباره مصنفًا محميًا متى انطبق عليه هذا الوصف، لكن مع اختلاف جوهري عن المصنفات الفردية أو الجماعية أو المشتقة، حيث يُعد هذا النوع من المصنفات ملكًا عامًا للدولة، كما نصّت على ذلك صراحة المادة السابعة من النظام، التي قررت أن: “التراث الشعبي يُعد ملكًا عامًا للدولة، وتمارس الهيئة السعودية للملكية الفكرية حقوق المؤلف عليه”، مما يعني أن ملكية الحقوق في هذا الإطار لا تعود لفرد أو جهة خاصة، بل تتولاها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بصفتها الجهة المختصة.
ولم تقتصر الأحكام النظامية على هذا الإطار العام، بل توسّعت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية في بيان صور التراث الشعبي التي يُعتبر كل منها مصنفًا محميًا ما دام مندرجًا ضمن التعبيرات الشعبية التقليدية في المملكة. ومن أبرز هذه الصور:
- التعبيرات اللفظية، مثل الحكايات والألغاز والأشعار الشعبية.
- التعبيرات الموسيقية، كالأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواءً كانت بالإلقاء المجرد أم مصحوبة بالموسيقى.
- التعبيرات الحركية، كالرّقصات والأشكال الفنية التي تؤدى في مناسبات احتفالية.
- التعبيرات الملموسة، وتشمل الرسومات، والحفر، والنقش، والمنتجات الخزفية، وأعمال الخشب والنسيج، والحقائب المنسوجة يدويًا، وأشغال الإبرة، والسجاد، والملبوسات التقليدية.
وقد شددت اللائحة على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة القيام بأي تطوير أو تعديل على التراث الشعبي دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، باعتبارها الجهة التي تمارس حقوق المؤلف على هذا النوع من المصنفات، مما يعكس الطابع الخاص الذي تتسم به الحماية القانونية المقررة له، بالرغم من كونه مصنفًا محميًا كسائر المصنفات الأخرى.
ويُفهم من هذه الأحكام أن التراث الشعبي السعودي لا يخرج عن نطاق المصنف المحمي من حيث المبدأ، بل يتمتع بوضع نظامي خاص من حيث ملكيته، وإجراءات استغلاله، وآليات حمايته، ولا سيما أن الحماية في هذا الإطار تهدف إلى الحفاظ على الأصول الثقافية والهوية التراثية الوطنية ضمن الإطار النظامي الدقيق المنصوص عليه.
وبهذا التحديد، يظهر بجلاء أن التراث الشعبي يُصنف ضمن نطاق المصنف المحمي، متى انطبقت عليه عناصر التعبير الإبداعي الجماعي وفق المعايير المحددة، وتؤول حقوقه إلى الهيئة المختصة، بما يمنع أي استغلال غير مصرح به أو أي مساس غير مشروع بهذا النوع من المصنفات ذات الطبيعة الاستثنائية في النظام.
وختامًا،
فإن الصورة النظامية الدقيقة التي رسمها المشرّع السعودي لمفهوم المصنف المحمي لا تترك مجالًا للبس أو الاجتهاد غير المنضبط، بل تؤسس لبنية قانونية محكمة تحيط بالمصنف من لحظة نشأته إلى مرحلة استغلاله وامتداد حمايته. فالنظام لا يكتفي بالتوصيف العام، بل يغوص في تفاصيل دقيقة تُميّز بين المصنفات الأصلية والمشتقة، والفردية والجماعية، وتحدد بوضوح من له الحق في مباشرة حقوق المؤلف، ومن يُستثنى من هذه الحماية ابتداءً. ومن خلال هذا البناء، تتجلى فلسفة الحماية بوصفها ليست مجرد أداة للمنع، بل منظومة دقيقة لضبط الحقوق على أسس واضحة ومنظمة.
وتكمن توصيتنا الدقيقة هنا في ضرورة أن يُراجع كل من يسعى إلى نشر أو استغلال أي عمل إبداعي فني أو أدبي أو علمي طبيعة العمل ذاته في ضوء نصوص النظام واللائحة التنفيذية، للتثبت من كونه مصنفًا محميًا بالفعل، وما إذا كانت له حماية نظامية سارية، ومن يملك الحقوق عليه، تجنبًا لأي تجاوز أو اعتداء على حقوق مؤلفين آخرين أو على حقوق عامة، خاصةً في حالات المصنفات الجماعية أو التراث الشعبي التي تنفرد بطبيعة قانونية خاصة لا يجوز التعامل معها كغيرها من المصنفات التقليدية.